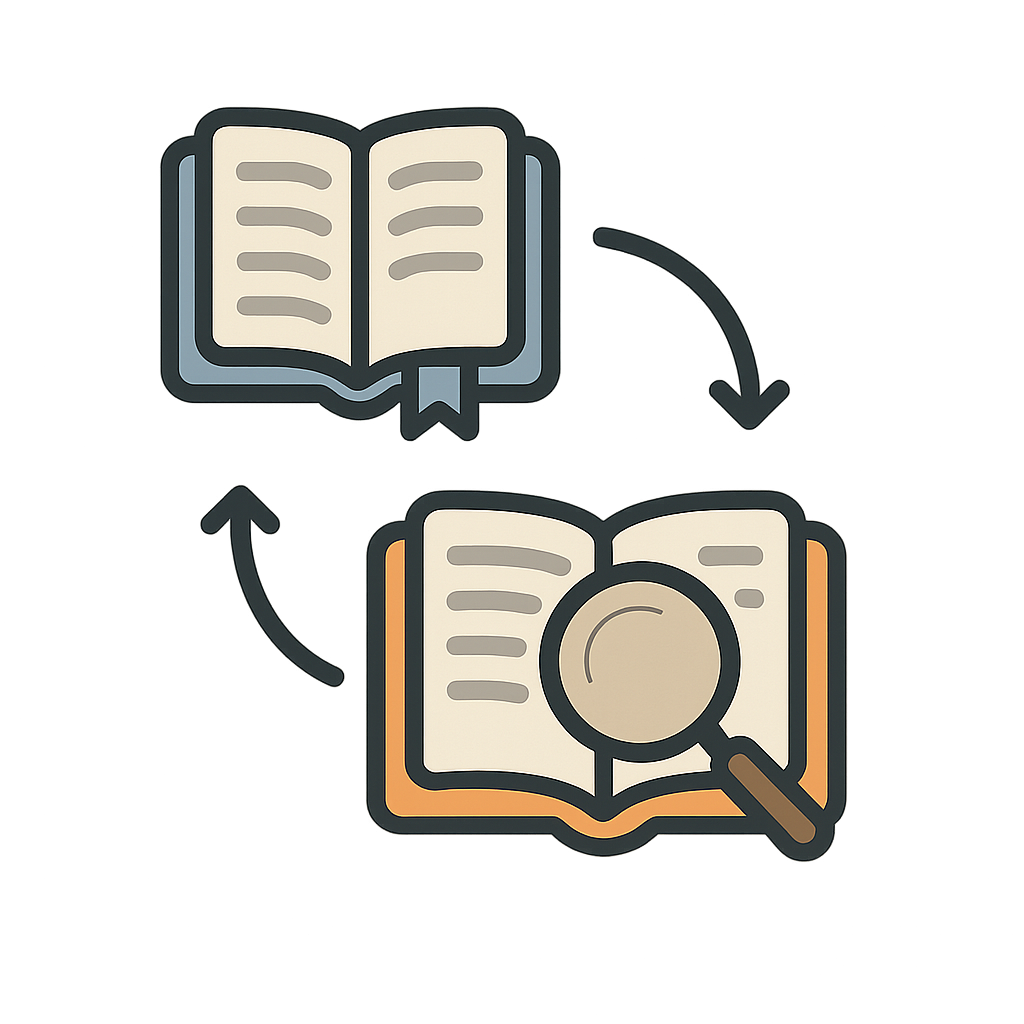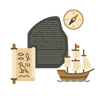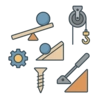الحجر الذي تكلم
لقرون طويلة، شعرت بالعالم يتحرك حولي، شاهدًا صامتًا منحوتًا من حجر الجرانوديوريت الداكن. دفء شمس مصر الحارقة كان يدفئ وجهي، وفيضانات النيل الباردة كانت تغمرني، لكنني لم أستطع الكلام. كانت الأسرار محفورة بعمق على سطحي، قصص تمنيت لو أرويها. كانت إحدى مجموعات نقوشي معرضًا لصور صغيرة متقنة—طيور رشيقة، وعيون يقظة، وثعابين ملتفة. وأسفلها، كان هناك خط متصل يرقص على وجهي، كأنه ملاحظات سريعة مدونة بين التجار. وفي الأسفل، كانت هناك لغة ذات حروف حادة ومألوفة، حروف بدت وكأنها تنتمي إلى عالم خارج الأهرامات. لما يقرب من ألفي عام، ظلت هذه الأصوات الثلاثة محبوسة بداخلي. كان العلماء والرحالة يتأملونني، يتتبعون خطوطي بأصابعهم، وعقولهم مليئة بالأسئلة التي أحمل إجاباتها. كانوا يرون الصور ولكن لا يسمعون الكلمات. كانوا يتعرفون على الحروف اليونانية ولكن لم يكن لديهم جسر يربطها بلغات الفراعنة المنسية. كنت صندوق ألغاز بلا مفتاح، مكتبة أبوابها موصدة. كنت أحمل قانون ملك، وصلوات كهنة، ولغة حضارة بأكملها، لكن كل شيء كان صمتًا. انتظرت، حابسًا أنفاس التاريخ داخل رئتي الحجرية، حتى أصبح العالم مستعدًا للاستماع. أنا حجر رشيد.
بدأت قصتي قبل أن أضيع بوقت طويل. لقد وُجدت في يوم محدد، السابع والعشرين من مارس، عام 196 قبل الميلاد، في مدينة منف القديمة بمصر. كان صانعيّ حريصين؛ فقد نقشوا مرسومًا من الملك الشاب، بطليموس الخامس، على سطحي. أراد أن يعرف الجميع في مملكته عن أعماله الصالحة وحقه الإلهي في الحكم، لذلك أمر بنشر رسالته بطريقة يمكن لجميع رعاياه المهمين فهمها. لهذا السبب أحمل ثلاثة خطوط. الهيروغليفية المقدسة، بصورها الجميلة والمعقدة، كانت للكهنة، حفظة التقاليد القديمة. والخط الديموطيقي، وهو كتابة أكثر شيوعًا وانسيابية، كان للمسؤولين الحكوميين وعامة الناس، لغة البلاد اليومية. وأخيرًا، كانت اليونانية القديمة للطبقة الحاكمة، حيث كان بطليموس نفسه جزءًا من سلالة يونانية حكمت مصر لأكثر من قرن. لم أكن فريدًا في ذلك الوقت؛ فقد تم إنشاء العديد من النسخ مني، تسمى "لويحات"، ووضعت في المعابد في جميع أنحاء البلاد. لكن القدر كان له مسار مختلف لي. مع مرور القرون، قامت الإمبراطوريات وسقطت. تلاشت معرفة قراءة الهيروغليفية القديمة من الذاكرة، وأصبحت لغة صور غامضة لا يستطيع أحد فهمها. تهدم معبدي، وتحطمت، وفُقد نصفي العلوي إلى الأبد. في النهاية، أصبحت مجرد كتلة حجرية مفيدة، وحُملت بعيدًا لأُستخدم في أساس جدار في حصن، ورسالتي العظيمة دُفنت ونُسيت.
تحطم صمتي الطويل بقعقعة مجرفة. كان ذلك في الخامس عشر من يوليو، عام 1799. كان جندي فرنسي، جزء من جيش نابليون في مصر، يعمل على تقوية حصن. كان اسمه بيير فرانسوا بوشار، وبينما كان يحفر بالقرب من بلدة رشيد، التي أطلق عليها الفرنسيون اسم "روزيت"، اصطدم بشيء صلب. كنت أنا. اجتاحتني موجة من الإثارة عندما أُخرجت من التراب إلى ضوء الشمس مرة أخرى. لاحظ الجنود على الفور شيئًا استثنائيًا. لم يتمكنوا من قراءة الصور أو الخط الغريب المتصل، لكنهم تعرفوا على اليونانية في الأسفل. أدرك القائد الإمكانات على الفور: إذا كانت الخطوط الثلاثة تقول نفس الشيء، فيمكن استخدام اليونانية لفك شفرة الخطين الآخرين. لقد أصبحت مفتاحًا. أُرسلت إلى القاهرة، حيث بدأ العلماء السباق الفكري العظيم لفك شفرتي. لسنوات، كافحوا. حقق عالم إنجليزي موسوعي، رجل لامع يدعى توماس يونغ، أول إنجاز حاسم. لقد أدرك أن بعض الهيروغليفية داخل الأشكال البيضاوية، التي عرفها بشكل صحيح على أنها "خراطيش"، تهجئ اسمًا ملكيًا—بطليموس—بشكل صوتي. كان على الطريق الصحيح، لكنه لم يتمكن من حل اللغز بأكمله. كان النصر النهائي من نصيب عبقري فرنسي شاب، جان فرانسوا شامبليون، الذي كرس حياته كلها لفهم مصر القديمة. بنى على عمل يونغ، لكن كانت لديه فكرة ثورية. ماذا لو لم تكن الهيروغليفية مجرد صور أو مجرد حروف، بل مزيج معقد من كليهما؟ قارن بلا كلل بين خطوطي، وعمل ليل نهار. تقول الأسطورة إنه في السابع والعشرين من سبتمبر، عام 1822، تمكن أخيرًا من فك الشفرة. اقتحم مكتب أخيه وهو يصرخ "لقد وجدتها."—ثم أغمي عليه من شدة الإرهاق والإثارة. لقد فعلها. لقد أعاد لي أقدم أصواتي، ومعه صوت الفراعنة.
مع اكتشاف شامبليون، لم أعد مجرد قطعة مكسورة من مرسوم ملكي. لقد أصبحت المفتاح الوحيد الأكثر أهمية لفتح الماضي. بسببي، تمكن العلماء الآن من قراءة النقوش على جدران المعابد، وفهم التعاويذ في كتاب الموتى، وتعلم تاريخ وحضارة وقوانين وحياة يومية لحضارة ظلت صامتة لآلاف السنين. تحولت من حجر إلى جسر يربط العالم الحديث بالعالم القديم. لم تنته رحلتي. بعد فترة وجيزة مع الفرنسيين، أخذني البريطانيون ومنذ ذلك الحين أقيم في المتحف البريطاني في لندن. يأتي ملايين الأشخاص من جميع أنحاء العالم لرؤيتي كل عام. يضغطون بوجوههم على الزجاج، محاولين تخيل الأيدي التي نحتتني والعقول التي فهمتني أخيرًا. حتى أن اسمي، "حجر رشيد"، دخل اللغة كمصطلح لأي شيء يمثل مفتاحًا حاسمًا لفهم شيء جديد أو معقد. قصتي هي شهادة على الفضول البشري والمثابرة. إنها تظهر أنه حتى عندما يبدو أن المعرفة قد ضاعت إلى الأبد، فإن العمل الدؤوب للناس، أحيانًا عبر بلدان وأجيال مختلفة، يمكن أن يعيدها إلى النور. أنا دليل على أن كل لغز له حل، وأنه من خلال فتح أسرار ماضينا المشترك، نتعلم المزيد عن أنفسنا ويمكننا تخيل مستقبل أكثر حكمة.
الأنشطة
قم بإجراء اختبار
اختبر ما تعلمته من خلال اختبار ممتع!
كن مبدعًا بالألوان!
اطبع صفحة من كتاب التلوين حول هذا الموضوع.