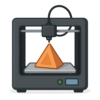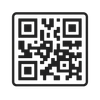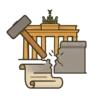الليلة التي سقط فيها الجدار
اسمي أنيا، وفي خريف عام 1989، كنت مجرد فتاة في الخامسة عشرة من عمري أعيش في برلين الشرقية. بالنسبة لي، لم تكن برلين مدينة واحدة، بل كانت مدينتين. مدينتي، ومدينتهم. وكان يفصل بينهما الجدار. لم يكن مجرد جدار، بل كان وحشاً خرسانياً رمادياً يمتد عبر قلب مدينتنا، مزوداً بأسلاك شائكة وأبراج حراسة. لقد كان تذكيراً يومياً بأننا كنا محاصرين. كان يقسم الشوارع والمنازل وحتى العائلات. كان جداي يعيشان في برلين الغربية، على بعد بضعة كيلومترات فقط، لكنهما كانا بعيدين وكأنهما يعيشان على سطح القمر. لم أرهما قط إلا في الصور الباهتة التي كانت أمي تحتفظ بها بعناية. كانت حياتنا في الشرق رمادية ومنظمة. كنا نقف في طوابير للحصول على الخبز، وكانت سياراتنا من طراز ترابانت تصدر أصواتاً غريبة وتنفث دخاناً أزرق. لكن على الرغم من اللون الرمادي، كانت هناك ألوان في حياتنا. كانت موجودة في دفء شقتنا الصغيرة، وفي رائحة كعك جدتي، وفي الضحك الذي كنا نتقاسمه حول مائدة العشاء. في ذلك الخريف، كان هناك همس في الهواء، همس تغيير. سمعنا قصصاً عن احتجاجات سلمية في بولندا والمجر. كان الناس يتوقون إلى الحرية، وبدأ شعور بالأمل، هش ولكنه عنيد، ينمو في قلوبنا. كنا نتساءل: هل يمكن أن يحدث ذلك هنا أيضاً؟ هل يمكن لوحشنا الخرساني أن يتصدع يوماً ما؟.
في مساء يوم 9 نوفمبر 1989، تغير كل شيء. كان يوماً عادياً بارداً، وكنا مجتمعين حول جهاز التلفزيون الصغير ذي اللونين الأبيض والأسود. فجأة، ظهر على الشاشة مسؤول حكومي اسمه غونتر شابوفسكي. كان يتحدث في مؤتمر صحفي، وبدا مرتبكاً بعض الشيء وهو يقرأ من قصاصة ورق. ثم قال الكلمات التي ستغير مجرى التاريخ. قال إن قيود السفر لمواطني ألمانيا الشرقية سيتم رفعها. سأله صحفي متى سيدخل هذا القرار حيز التنفيذ. تردد شابوفسكي، ثم قال: "على الفور، دون تأخير". خيم صمت مذهول على غرفتنا. نظرنا إلى بعضنا البعض، هل سمعنا ما قاله للتو؟ هل يمكن أن يكون ذلك صحيحاً؟ بدا الأمر مستحيلاً، مثل حلم. قال أبي بصوت خافت: "لا يمكن أن يكون الأمر بهذه البساطة". لكن الأمل كان شعوراً قوياً. انتشر الخبر كالنار في الهشيم في جميع أنحاء المدينة. بدأ الناس يخرجون من شققهم، في البداية بتردد، ثم بثقة أكبر. قررنا أن نذهب ونرى بأنفسنا. انضممنا إلى حشد متزايد من الناس يسيرون نحو نقطة تفتيش بورنهولمر شتراسه. كان الهواء مليئاً بمزيج غريب من التوتر والإثارة. كان الجميع يتهامسون ويتساءلون. هل سيفتحون البوابات حقاً؟ وقف حرس الحدود في حيرة، وهم يتلقون أوامر متضاربة عبر أجهزة اللاسلكي الخاصة بهم. كانوا متجهمين ومسلحين، لكن كان بإمكانك رؤية الارتباك في أعينهم. انتظرنا لساعات، والبرد يقرص وجوهنا، لكن لا أحد غادر. ثم، حوالي الساعة 11:30 ليلاً، حدث ذلك. تحت ضغط الحشد الهائل الذي كان يهتف "افتحوا البوابة."، استسلم الحراس. انفتحت البوابة المعدنية بصرير عالٍ. لبرهة، تجمد الجميع، ثم اندفع هدير من الفرح الخالص. تدفقنا عبر البوابة، موجة من الناس تذوق طعم الحرية لأول مرة.
كانت خطواتي الأولى في برلين الغربية سريالية. شعرت وكأنني دخلت إلى عالم آخر، عالم بالألوان الزاهية. بعد الشوارع ذات الإضاءة الخافتة في الشرق، كانت أضواء النيون الساطعة في الغرب مبهرة. كانت هناك روائح لم أشمها من قبل، رائحة الكباب من أكشاك الطعام، ورائحة القهوة الطازجة، ورائحة العطور من المتاجر الأنيقة. كانت أصوات الموسيقى الصاخبة تتدفق من الحانات، وكانت واجهات المتاجر مليئة بالسلع التي لم أرها إلا في المجلات المهربة. كان الأمر مربكاً ورائعاً في نفس الوقت. والأمر الأكثر روعة كان الترحيب الذي تلقيناه. كان سكان برلين الغربية ينتظروننا على الجانب الآخر. كانوا يصفقون ويهتفون، ويقدمون لنا الشمبانيا والشوكولاتة والزهور. عانقنا الغرباء، وهم يبكون دموع الفرح معنا. لم يكن هناك شرق أو غرب في تلك الليلة، كنا مجرد ألمان، متحدين بعد عقود من الانقسام. أتذكر رجلاً عجوزاً وضع موزة في يدي وقال: "مرحباً بك في الحرية". كانت الموزة فاكهة نادرة وفاخرة في الشرق. حملتها وكأنها كنز، رمز صغير لكل ما حُرمنا منه. في تلك الليلة، رقصنا في الشوارع مع أناس لم نلتق بهم من قبل، وشعرنا بإحساس بالانتماء والبهجة لم أكن أعتقد أنه ممكن. لقد كان حلماً تحقق، ليس فقط بالنسبة لي، بل لملايين الأشخاص الذين كانوا محاصرين خلف جدار من الخرسانة والخوف.
في الأيام والأسابيع التي تلت ذلك، تحول الجدار نفسه. لم يعد رمزاً للقمع، بل أصبح أكبر لوحة فنية في العالم. جاء الناس من كل مكان بمطارق وأزاميل ليبدأوا في هدمه، قطعة قطعة. أطلقوا عليهم اسم "ماورشبشته"، أو "نقاروا الجدار". كان كل نقرة على الخرسانة بمثابة إعلان للحرية. تحولت أجزاء من هذا الهيكل البغيض إلى هدايا تذكارية ملونة، شظايا من التاريخ يمكن للناس الاحتفاظ بها. لم يعد الجدار يفصلنا، بل أصبح شيئاً يمكننا تفكيكه معاً. وبعد فترة وجيزة، تمكنت أخيراً من رؤية جديّ. كان اللقاء مؤثراً للغاية، مليئاً بالدموع والعناق الذي طال انتظاره لسنوات. توحدت عائلتي من جديد، وفي العام التالي، توحدت ألمانيا بأكملها. تلك الليلة في نوفمبر علمتني أن الجدران التي يبنيها الناس لتقسيمنا ليست قوية كما تبدو. علمتني أن رغبة الإنسان في التواصل والحرية هي قوة لا يمكن وقفها. لقد أظهرت لي أن الناس العاديين، عندما يتحدون بأمل مشترك، يمكنهم تغيير العالم. لن يمحى هدير ذلك الحشد وصرير تلك البوابة من ذاكرتي أبداً، لأنه كان صوت انهيار جدار وصوت ولادة مستقبل جديد.
الأنشطة
قم بإجراء اختبار
اختبر ما تعلمته من خلال اختبار ممتع!
كن مبدعًا بالألوان!
اطبع صفحة من كتاب التلوين حول هذا الموضوع.